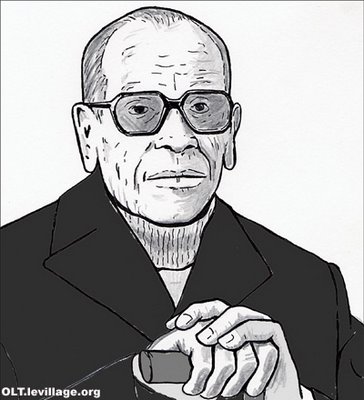كان يوماً شبه مشمساً، يوم من تلك الأيام التي تظهر فيها الشمس حيناً ثم تختفي أحياناً أخرى خلف السحب المتناثرة. تلك السحب المتناثرة التي تتراوح ألوانها بين الأبيض الناصع البياض و الرمادي الداكن المنذر بقدوم الغيث. و على السواء بيضاء كانت أم رمادية كانت السحب كثيفة و ذات أشكال عشوائية و كلها تتسابق في أن تُخفي الشمس خلفها فتخلق عن دون قصد إضاءة هادئة لا تُضطر معها أن ترخي جفونك كي تتجنب أشعة الشمس المباشرة.
كنت متأخراً على الميعاد المتفق عليه بالرغم من قيامي مبكراً و كان لابد أن أُسرع و أتحرك من منزلي الواقع على أحد التلال الثلاثة التي تحد مدينة تونس من الشمال و تحديداً كان منزلي أعلى تلة "قمرت" التي تجاور تلتي "سيدي بوسعيد" و "قرطاج" و يطلون مجتمعين على البحر من ناحبة و على المدينة الممتدة بطول الوادي من الناحية الأخرى.انطلقت بالسيارة نحو وسط البلد حيث مكان اللقاء المتفق عليه بجانب فندق "أبي نواس" و قد تعودت كل يوم عند الخروج من البيت على إلقاء نظرة سريعة على البحر كي أتابع تغير لونه على حسب تغير لون السماء و أحوالها. كانت تلك السحب المبعثرة قد استطاعت أن ترسم على البحر الهادئة طباعه لوحة مكونة من مساحات من الأزرق الشديد القتامة و مساحات أخرى من اللون المرمري الشفاف الذي يكاد يكشف عورة الرمال تحت صفحته، طبعت تلك اللوحة أثرها في نفسي على مهل قبل أن أدرك أني لابد أن أسرع إن كنت أريد أن أصل قبل ميعاد التحرك.
يوم الأحد صباحا تكون الطرق شبه خالية من السيارات و قد ساعدني ذلك في طي الطريق بين الدار و شارع محمد الخامس حيث الفندق في حوالي ربع الساعة. توجهت إلى المرفأ حيث وجدت بقية المجموعة و قد وقفوا إلى جانب سياراتهم يتكلمون و يتناقشون في ترتيبات بقية اليوم. لم أكد أترجل من السيارة حتى أقبلت عليَ و في عينيها نظرة حاسمة لكن حنونة...
- هل كان الحلم ممتعاً؟
- أي حلم؟
- الذي أخر صحيانك
- لم يكن الحلم الذي أخرني
- ماذا كان إذن؟
- البحر المتغيرة أحواله
- عذر أقبح من ذنب
- و لكنني لست آخر الحاضرين فرأيسة المجموعة نفسها لم تصل بعد
- و هل يعفيك هذا؟
- لازلت مذنبا إذن!
- و لكنك المذنب المفضل إليَ
ابتسمت عيناها قليلا و بادلتها الابتسام ثم هتف يناديها أحد أفراد المجموعة فانطلقت نحوه و انشغلوا في تقسيم الماعون الذي تم تجميعه طوال الأيام الفائتة من المتبرعين بين السيارات التي تم اختيارها كي تقودنا إلى الجبل، لم تكن سيارتي من بين تلك السيارات حيث فضلت تركها بالمرفأ لكونها عهدة من الشركة التي أعمل بها. قمنا بتقسيم أنفسنا بين السيارات و لم تكن هي في نفس السيارة التي كانت من نصيبي.
كانت القافلة متجهة إلى مدرسة نائية تقع في وسط الصحراء وتم اختيارها للزيارة و المساعدة بسبب شدة فقر مواردها و عدم اهتمام الدولة بها و لبعدها عن مساكن الأطفال المسجلين فيها، كان لموقعها دور في سوء أحوالها حيث الطرق شديدة التعرج و التلال كانت تقف حائلا بينها هي و القرية المجاورة لها و التي تسمى "الرقبة" من جهة و بقية الحقول و الامتداد السكاني من جهة أخرى. الهدف كان أن نمضي اليوم مع الأطفال كي نرفع من روحهم المعنوية ثم نعرج على الإدارة كي نرى كيف يمكن مساعدتهم في المستقبل.
بدأت رحلتنا على الطريق السريعة و كانت السحب قد بدأت في إرسال دفقات من الأمطار الخفيفة و لكن ذلك لم يحول دون رؤية المناطق الفارغة المرمرية في جسم السحب التي بدت و كأنها تلملم من نفسها استعداداً لما يبدو أنه أكثر من دفقات خفيفة. كانت "الرقبة" تبعد حوالي مائتي كيلومتر عن العاصمة في اتجاه الغرب التونسي و لم تكن تقع على الطريق الرئيسة بل اضطررنا إلى سلوك طريق آخر صغير فرعي يمتد وسط الحقول. بعد فترة من السير في هذا الطريق تكشف أمامنا منظر خلاب خطف حواسي عن كل ما حولها و حتى عن صوت فيروز التي كانت تشدو للقدس العتيقة.
كان الجبل أسمراً شامخاً وسط السحب و محاطاً ببعض التلال الصفراء و البنية التي تنم عن فقر الزرع و ندرته و كانت لحظة انكشافه مبهرة و بدت التلال المجاورة له و كأنها الخدم الساهر على خدمة سيده العليَ شأنه. منظر الجبل لم يوحي بأنه يوجد من يسكن أو يتعلم في ثناياه فهو من تلك الجبال التي تعتقد أنها وُجِدت فقط كي تكون نِداً للزمن و شاهداً عليه دون أن تنال منها أكثر من رؤيتها و التملي بجمالها.حاولت أن أحيط بهذا الجمال بكاميرتي الفوتوغرافية و لكني فشلت في قنص ذلك الجمال الذي تملكني و جاءت الصور منقوصة... و بدأت أفكر فيمن سيساعد من و تعجبت، أنساعدهم نحن بالماعون أم يساعدونا هم بالسماح لنا بالنظر إلى جنتهم.

انتهت الطريق الصغيرة و دلفنا إلى الصحراء و كنا لنزال على مسافة غير قليلة من "الرقبة" المختفية وراء الجبل، السيارات كانت تشكل صفاً يسير رويداً بسبب وعورة مسلكنا و على جانبنا سار عدد من الفلاحين ممتطين لدوابهم و قد غطوا رؤوسهم بقبعات من الخوص التي عرفت فيما بعد أنها من عادات الفلاح التونسي.رفع أحد الفلاحين بجوارنا يده مُرحباً و كأنما كنا مقبلين على باب داره فبادلناه التحية، و مضينا في طريقنا و أخذت الطريق ترتفع شيئاً فشيئاً فوق التلال إلى أن بدأنا نرى أطفال متشابكي الأيدي يسيرون في نفس الاتجاه و كانوا يصارعون وعورة الطريق بأقدام صغيرة و لكن بخفة و مهارة ثقلتها الخبرة فتارة يتقدمون بالقفز و العند و تارة بالتروي و تخير موطئ القدم. كدت أشعر بالأسف لقسوة الطريق على أجسامهم الصغيرة لكني فكرت أن الطريق الوعرة مدرسة في حد ذاتها و ربما ما يتعلموه فيها كل يوم هو أخير و أقيم مما نتعلمه نحن في مكاتبنا المكيفة. ظهر في الأفق مبنى أبيض (ناصع البياض في بعض أجزاؤه) يبدو عليه حداثة البناء على الرغم من الدهان المتهالك لبعض الحيطان. اقتربنا من البوابة و إذا بنا نجد جحافل من الطلبة خارجها و لاحظنا أن كلهم تقريباً من الأولاد و جميعهم أكبر سناً من أطفال المدرسة و عرفنا بعد ذلك أنهم من نفس القرية التي أتى منها الأطفال و لكنهم من المدرسة الإعدادية البعيدة عن هذا المكان و لكنهم أتوا بعد أن سمعوا بالزيارة ليظفروا ببعض الهدايا مع أخواتهم
الصغار.
كانت المدرسة من الداخل في شدة البساطة و لكنها كانت نظيفة، كانت مكونة من ثلاثة أضلاع متعامدة من المباني التي تحيط بحوش متسع يوجد في منتصفه هيكل أشبه بالنصب التذكاري و يرتفع فوقه علم تونس. المدرسة كانت في حضن الجبل و كانت رؤية التلال من المدرسة سهلة جداً (أيها التعساء الصغار... آه لو تدركوا الجمال الذي يحيط بكم... ستكبرون يوماً لتجروا جري الوحوش و تتنافسوا فيمن يخرج من هذه الجنة إلى جحيم العاصمة). كان معظم الأطفال في الفصول في انتظارنا و كنا قد بدأنا في سماع أصواتهم و رؤية وجوههم المطلة من الشبابيك و الأبواب و كانوا كحبات الهواء في الماء المغلي منتشرون في كل أنحاء المدرسة و في حراك مستمر، تحرك زملائي في اتجاه الفصول إلا أنني لم أذهب معهم و وجدتني سارحاً أتجول في المدرسة إلى أن أصبحت وحيداً و استوقفتني لوحة بليدة الشكل و لكن عظيمة المعنى مرسومة على أحد حوائط المبنى و كانت تقول:
"العلم يبني بيوتاً لا عماد لها ، و الجهل يهدم بيوت العز و الشرف"
كانت تلك أول مرة أقرأ فيها هذه المقولة و حتى الآن لا أعرف قائلها و لكني عجبت أني تعلمت شيئاً جديداً في تلك المدرسة البعيدة كل البعد عن مسار حياتي فصرت مثلي كمثل هؤلاء الأطفال و هم يقرءوها لأول مرة. أخذت أفكر في المقولة و شدة دقتها و تعبيرها عما نمر به و كأنما قد عرف قائلها بما سيحدث لنا يوما... ً و بينما أنا سارحاً مع أفكاري و متأملاً للحائط ذي المقولة إذا بها تربت على كتفي.. التفت إليها لأجد ابتسامة رقيقة قد ارتسمت على شفتيها....
- لماذا تقف وحدك؟
(أشرت إلى الحائط أمامي ثم نظرت إليها بطرف عيني و قلت)
- جميلة.. أليس كذلك؟
- من قائلها؟
- لا أدري
- هل ستبقى؟
- و لماذا أبقى في "الرقبة"؟
لمحت ذرات غضب في عينيها و توارت البسمة المعهودة ثم قالت في اقتضاب
- تفهم قصدي
- نعم أفهم
- حسناً... هل ستبقى؟
- لا توجد أرض عربية تستطيع أن تحتويني
- أغرور هذا أم ثقة زائدة بالنفس؟
- بل خوف من عذاب لا مفر منه إن بقيت
- أي عذاب؟
- ضيق التنفس... أتعرفينه؟
- نعم أعرفه.. أسبابه عندي تختلف.. و لكني بعد لم أفهم
- قسموا أرض العرب و لم تنتج القسمة عن جزء يكفيني فكلهن صغار عني...
فإما أن أبقى و أتعذب أو أرحل و أتنفس..
و أنتِ...
هل ستبقين؟
- مقاسها يناسبني
- ماذا تعنين؟
- لا أفضل الملابس الفضفاضة
- فهمت... و لكن ماذا ستفعلين؟
- أفتش في ثنايا تلك الأرض
- هي مليئة بالكنوز... حتى في حضن هذا الجبل.. أليس كذلك؟
- بلى
التفت إلى منظر التلال الماثلة أمامي و هي لازالت بجانبي و قد تبعتني عيناها و أحسست بأصابعها و قد لامست أصابعي في وهن قبل أن تسحبها لتزيح بعض من شعراتها المتطايرة على وجهها بفعل النسيم ثم مالت بشفتيها على أذني و همست..
- اختلفت الطرق و اتفقت المنى!
- قد نلتقي
- ربما... سأسأل عن أخبارك في كل حال
- لا أستطيع أن أعد بالمثل
نظرت إليَ باستغراب و قالت..
- و لم لا؟
- لست قارٍ بعد و لا أعرف متى أستقر و لا أين
- و ما يمنع المرتحل من الوصل؟
- أتعرفين حسن بن محمد الوزان؟
؟Jean-Leon de Medici-
- هو ذاك... و هو كذلك يوحنا الأسدي الأفريقي
- و ما صلته بسؤالك عتي؟
- أشعر أني سأنتهي على حاله..
ولد بمدينة و قذف منها إلى أخرى...
و ارتحل مجدداً... ثم سيق إلى أقصى الأرض..
فكثُرت أسماؤه و صفاته...
فتجدينه في بعض أنحاء المعمورة الغرناطي و بأخرى الفاسي..
و في أخرى الأفريقي...
و في ترحاله سُلِب حق الوصل..
حتى استقر حيث أسكن في "قمرت"
أخشى أن أصير مثله....
و الرحالة لا يملك وعده.
تدفقت من عينيها ملامح الحزن و سرعان ما فاضت على وجنتيها و شفتيها ثم رويداً تبدلت ملامحها فصارت أكثر دفئاً و قالت
- أتعرف ماذا كان يكفيه في ترحاله؟
- ماذا تعتقدين؟
L'amour, c'est suffisant-
لم تمنحني فرصة للاختلاف بل اقتربت مني في هدوء و مالت برأسها عليَ و أحسست بحرارة وجهها قرب أنفي و بملمس أصابعها فوق كتفي ثم أطبقت بشفتيها بقبلة على خدي و أحسست بطرف شفتيها و قد لامس طرف شفتاي عن دون قصد منها....
بنفس الهدوء تراجعت قليلاً حتى تلاقت عينانا لحيظات قليلة و لكنها كانت كافية لكل واحد منا كي يلقي للآخر بحبات وجده..
تركتني و انسحبت بهدوئها المعهود من محيطي (و حياتي) و وجدتني أرجع بنظري إلى الجبل و تلاله المحيطة و وددت لو أنه ضمني إلى حضنه الدفيء....
هممت بالعودة للمجموعة و لم يكن أحد قد لاحظ غيبتي و كانوا قد بدءوا يتوزعون على الفصول و في أثناء سيري فوجئت بشيء يصطدم بجسدي بقوة و اندفاع من الخلف، التفت خلفي في دهشة لألمح طفل لا يتعدى الخامسة من عمره يرتدي فانلة بيضاء و سترة كحلية و قد سقط على الأرض بفعل ارتطامه بي قبل أن يثب واقفاً و كأن شيئاً لم يكن ليعاود جريه. أمسكت به قبل أن يعاود الجري و كانت على وجهه ابتسامة المنتصر و تطل من عينيه علامات الذكاء الحاد و نظراته تنم عن فطرة عربية بدوية نمت في حضن هذا الجبل. سألته عن اسمه فجاوبني هاتفاً و قال "مالك" ثم حاول الفرار من بين يدي و كأنما يريد الهرب من شيء ما أو الإسراع لاقتناص شيء ما. كانت حركات يده و جسده تزخر بطاقة لا تُستنفذ و لم تستطع قبضتي أن تبقيه أكثر من ذلك حيث انطلق مجدداً ليرتطم تلك المرة بمدير المدرسة الذي ظننت أنه سيعاقبه و لكنه اكتفى لدهشتي بملاطفته و مداعبته قبل أن يدعه كي يذهب إلى فصله.

عندما لحقت بالمجموعة اكتشفت أنه تم توزيعي على فصل الأطفال الأصغر سنا و عند دخولي الفصل وجدته يموج بحركة عشوائية و الأطفال يصيحون بلا سبب و بلا توقف و أخذ بقية زملائي يحاولون تهدئتهم حتى يقوموا بتوزيع الهدايا عليهم. اقترح أحدنا أن نقوم برسم أشكال على السبورة و نسألهم عنها و نعطي لمن يجيب بالصواب أحد الهدايا و بالفعل بدأنا و كان من الواضح أن "مالك" و طفل آخر (أتضح فيما بعد أنه ابن ناظر المدرس) هما قائدا هذا الفصل فبعد أن جلسا و استقرا في درجيهما تبعهما بقية الفصل. بدأ الرسم و التخمين وقام زميلنا برسم شمس على السبورة و سألناهم عنها فهتف ابن الناظر أولا و تبعه الآخرون و هتفوا "سمشون" فصحح لهم زميلي قائلا " شمسٌ " فبدا الاستغراب على وجوههم الصغيرة قبل أن يعيدوا الكرة و يهتفوا "سمشون" و كأنما غير مقتنعين بما قلنا... أوقفتنا أحد بنات المجموعة و قالت إن الشمس تُعرف في تلك الأنحاء من تونس باسم "سمش" فصرنا نحن جهلاء "الرقبة". آثر زميلي السلامة و بدأ برسم الفواكه و الغلة حتى يضمن أكبر قدر من الاتفاق بيننا و بينهم و بدأ برسم بعض من أصابع الموز و على الفور صاح ابن الناظر ولحق به الآخرون "بناناتون" و كان عودٌ على بدء.
شعرت بالحنين للجلوس إلى الدرج و تذكرت أيام مدرسة الفرير بالكربة و در وجها التي احتضنتني و وجدتني أتجه نحو آخر الفصل لأجلس بأحد الدروج و إذا بالطفلتين الجالستين أمامي تلتفتان إليَ بابتسامة خجولة... حييتهما فإذا بهما تضحكان و تتهكمان على لهجتي الغريبة على أذنيهما، سألتهما عن اسميهما و قالتا "هالة" و "هناء"... رددت قائلا أنا "أحمد" فقالتا شنوا الأحوال سي أحمد.....
تركتهما للمسابقة و الجوائز و أخذت أفكر..
فكرت في كل تلك الثنايا التي تملأ تلك الأرض التي ورثناها..
أليست هي المصدر و الممول لتلك الحضارة؟
تحت كل ثنية أرض و في حضن كل جبل و وادٍ عالم كامل يزخر ببنات أفكار تلك الحضارة...
فإذا ظننا أنها صارت أرضاً بور فاجأتنا من حيث لا ندري بجديد مثري...
إنها أرض تستحق الخدمة .... و العودة.
و كما قال أعرابي "غفلنا و لم يغفل الدهر عنا، فلم نتعظ بغيرنا، حتى وُعِظَ غيرُنا بنا، فقد أدركت السعادة من تنبه، و أدركت الشقاوة من غفَل، و كفى بالتجربة واعظاً"